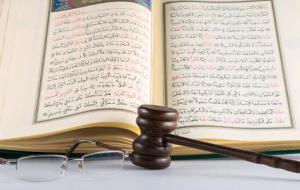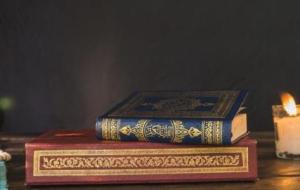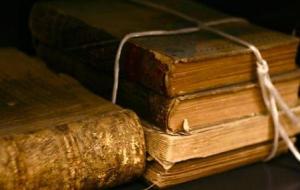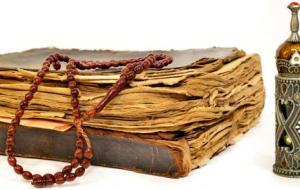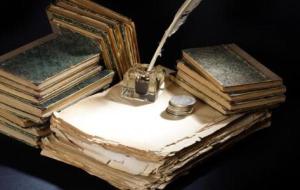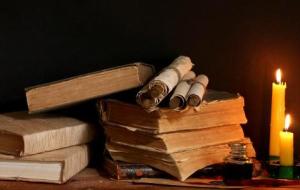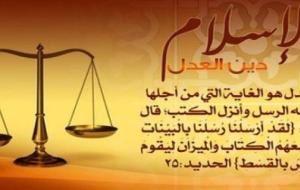الفرق بين عدة المطلقة وعدة الأرملة تختلف عدّة المطلقة عن عدة المتوفى عنها بزوحها بالمدة وبحال المرأة؛ فإن كانت العدّة من وفاةٍ فمدتها أربعة أشهرٍ وعشرة أيامٍ، ولا تختلف المدة باختلاف حال المرأة؛ أي أنّ المدة ذاتها للمرأة الصغيرة والكبيرة، والمدخول بها وغير المدخول، أمّا الحامل المتوفى عنها زوجها فتعتدّ بأبعد الأجلين، ولا تختلف أحكام العدة باختلاف حال المرأة؛ فعليها الالتزام بالأمور الواجبة في العدة، أمّا العدة من الطلاق فتختلف بحال المرأة؛ فالمرأة المطلقة قبل الدخول لا تجب عليها العدة،
الفرق بين صلاة الشُّروق وصلاة الضُحى يُفرّق بين صلاتي الشُّروق والضُحى؛ بأنّ المُعتاد على أداء صلاة الضُحى؛ فيؤديها ما بين ارتفاع الشّمس إلى وقت زوالها، وقد يُفرّق بالقَوْل بأنّ مَن يبقى جالساً في مُصلّاه إلى وقت ارتفاع الشّمس، ثمّ يُصلّي، فإنّ صلاته تعدّ صلاة إشراقٍ؛ بالنَّظر للجلوس الذي قبلها، وتصلح أن تكون صلاة ضُحى؛ بالنَّظر إلى وقت أدائها، كما ثبت عن عبدالله بن عبّاس -رضي الله عنهما- أنّ صلاة الشُّروق تؤدّى أوّل وقت صلاة الضُحى، فأوّل وقت الضُحى يبدأ بطلوع الشّمس، وفسّر أيضاً قَوْله
الفرق بين الشريعة والفقه الشريعة تطلق بشكلٍ عامٍ على كلّ ما شرعه الله -سبحانه- من العقائد والأخلاق والأعمال، وتطلق بصفةٍ خاصةٍ على كلّ ما شرعه الله من الأحكام العملية فقط دون الأخلاقية والاعتقادية منها، والواردة في الكتاب والسنة، أمّا الفقه فهو العلم بالأحكام العملية الشرعية المستنبطة من الأدلة التفصيلية، فالفقه محصورٌ بالأحكام العملية فقط، الصادرة من العبد غاية التقرب من ربه، والتي تصدر أحكامها استنباطاً من أدلة الكتاب والسنة، وبناءً على ما سبق فالشريعة تتمثل بالأحكام المنزلة من الله، أمّا
الفرق بين الخلع والطلاق من أهمّ الفروق بين الطّلاق والخلع ما يأتي: الطّلاق لا يكون إلّا بإرادةٍ من الزّوج ووفق اختياره ورضاه وبلفظه، أمّا الخُلع فهو فسخٌ ويقع دون لفظ الزّوج، وليس شرطاً فيه رضاه واختياره. الخلع لا يستطيع الزّوج فيه إرجاع زوجته؛ فهو زوالٌ وحِلٌّ للعصمة الزوجيّة مقابل شيءٍ مادّيٍّ معلومٍ من قِبل الزوجين، ولا يحقّ له إرجاعها في أثناء عدّتها إلّا برضاها ورضا وليّ أمرها، وبحضور شاهدَين، ومهرٍ جديدٍ، وكتابٍ جديدٍ، أمّا الطلاق فتبقى فيه الزوجة على ذمّة الزوج ما دامت في عدّتها من
تعريف الحديث الموقوف الحديث الموقوف نوعٌ من أنواع الحديث النبوي، ويُعرّفه العلماء بأنّه الحديث الذي يُروى عن الصحابي من قوله أو فعله، سواءً كان موصولاً أو منقطعاً، ويصحّ استعماله في غير الصحابي مقيداً؛ كالقول مثلاً: موقوفٌ على ابن شهاب الزهري. حكم العمل بالحديث الموقوف الحديث الموقوف على الصحابي نوعان: النوع الأول: ما يأخذ حكم الحديث المرفوع؛ لأنّه لا مجال للاجتهاد فيه، فلا يُتصوّر أن يكون الصحابي قاله من قِبَلِ نفسه. النوع الثاني: ما يقبل الاجتهاد من الصحابي؛ لأنّ للرأي فيه مجالٌ، وهذا النوع
الحديث الموضوع يُقصد بالحديث الموضوع كما عرّفه المحدّثين أنّه الحديث الذي ثبت أنّه كذبٌ، ويعرّف الحديث الموضوع أيضاً بأنّه الحديث الكاذب المختلق المصنوع على الرسول عليه الصلاة والسلام، وحتى يطلق على الحديث موضوعاً لا بدّ أن يكون كذباً مختلقاً مصنوعاً، ويتفرّع الحديث الموضوع إلى قسمين بيانهما فيما يأتي: الحديث الموضوع عن قصدٍ؛ والباعث على وضع الحديث قد يكون الرغبة في إفساد الدين، أو لنصرة مذهب من وضعه، أو للتكسّب، أو بقصد التقرّب من الأمراء والسلاطين، أو زعماً بترغيب الناس في الدين. الحديث
الحديث المقطوع المقطوع في اللغة اسم مفعول من قطع، وهو ضد الوصل، أمّا اصطلاحاً فهو: الحديث الذي أُضيف للتابعي أو من هو دونه من فعلٍ أو قولٍ، والمقطوع يختلف عن المنقطع؛ والسبب في ذلك أنّ المقطوع من صفات المتن، أمّا المنقطع فهو من صفات السند، ففي الحديث المقطوع قد يكون السند متصلٌ إلى التابعي، ولا يعدّ الحديث المقطوع حجةً، حتى إن كان سنده صحيحٌ؛ لأنّ قول التابعي لا يعد حجةً فيُؤخذ ويُترك ممّا روى. شروط العمل بالحديث المقطوع لا يُحتج بالحديث المقطوع إلّا إذا توافرت فيه عدّة شروطٍ، وهي: أن يكون
الحديث المرسل المرسل في اللغة يطلق على الإطلاق وعدم المنع، وهو من الإرسال، ويُجمع على مراسيل ومراسل، والمُرسل بفتح حرف السين اسم مفعول، أمّا اصطلاحاً فقد تعدّدت تعريفات الحديث المرسل عند المحدّثين والفقهاء، فيذكر الفقهاء والأصوليين أنّ يقول الراوي الذي لم يلتقِ بالنبي -صلّى الله عليه وسلّم-: "قال رسول الله"، سواءً كان الراوي تابعي أو غير تابعي، صغيراً أم كبيراً، أمّا عند المحدّثين فالحديث المرسل هو ما رفعه التابعي إلى النبي -صلّى الله عليه وسلّم- من فعلٍ أو قولٍ أو تقريرٍ، أيّ أن يرفع التابعي
الحديث المتواتر الحديث المتواتر هو الحديث الذي رواه جمعٌ من الصحابة لا يمكن أن يتواطؤا على الكذب، مع إسناد الحديث إلى شيءٍ محسوسٍ، ويشترط الجمع في كلّ طبقةٍ من طبقات السند، والمقصود باستحالة تواطؤهم على الكذب؛ أي لا يمكنهم أن يكونوا قد اتفقوا على اختلاق الحديث، والشيء المحسوس أن يقولوا: سمعنا أو رأينا أو لمسنا أو حدّثنا، وتجدر الإشارة إلى أنّ علماء الحديث اختلفوا في عدد الجمع في كلّ طبقةٍ، فقيل أربعةٌ وقيل خمسةٌ وقيل غير ذلك، إلّا أنّه إن كان دون الأربعة يكون الحديث حينها حديثاً غريباً أو
الحديث الغريب معنى الغريب لغةً المنفرد، أو الشخص البعيد عن أقربائه، والغريب صفةٌ مشبهةٌ، أمّا معنى الحديث الغريب اصطلاحاً فهو ما انفرد بروايته راوٍ واحد فقط وقد يكون ذلك في كلّ طبقةٍ من طبقات السند، أو في طبقةٍ واحدةٍ من السند، وقد أطلق عليه بعض العلماء اسم الفرد من باب الترادف. أنواع الحديث الغريب الحديث الغريب من حيث تفرّده له وجوهٌ عدّةٌ، منّ أهمّها: التفرّد المطلق: وهو انفراد الراوي في طبقةٍ من طبقات السند برواية الحديث دون مشاركة أحدٍ له في روايته، فيكون بذلك حديثٌ لم يُعرف عن النبي -صلّى
تعريف الحديث الضعيف يُشتقّ معنى الحديث الضعيف لغةً من الضعف، فيُقال: ضعيفٌ؛ أي سقيمٌ وهزيلٌ، أمّا معناه اصطلاحاً فهو الحديث الذي يختلّ فيه شرطٌ من شروط الصحّة، ومن تلك الشروط اتصال سند الحديث؛ أي أن يكون كُلّ راوٍ في السند قد سمع عن شيخه بحيث يكون السند متصلاً سليماً من السقوط، وتشترط عدالة الرواة؛ أي استقامتهم في دينهم وأخلاقهم، وإتقانهم للحفظ بحيث يكونوا قادرين على أداء الحديث كما سمعوه، مع خُلو متن الحديث أو سنده من الشذوذ أو العلّة، والشذوذ معناه مخالفة رواية الثقة لمن هو أوثق منه، والعلّة
الإسلام أتى النّبي محمّد -عليه الصّلاة والسّلام- برسالة الإسلام العظيم إلى البشريّة جمعاء، وقد كانت تلك الرّسالة خاتمة الرّسالات السّماويّة من لدن آدم -عليه السّلام-، كما كانت تلك الرّسالة مهيمنة على الرّسالات وناسخةً لها، فلا يقبل إسلام إنسان وإيمانه ما لم يسلّم بصدق هذه الرّسالة ويؤمن بها وبنبيّها الخاتم، وقد اتّسمت تلك الرّسالة عن غيرها من الرّسالات بأنّها لم تصلها أيدي التّحريف بل حفظ الله تعالى كتابه العزيز الذي يمثّل دستور هذه الأمّة من التّحريف، فما هو تعريف الإسلام من خلال بيان أركانه،
معنى الحديث الموضوع عرّف علماء الأمة الإسلامية الحديث الموضوع بأنّه الحديث الذي اختلقه بعض الناس عن عمدٍ أو غير عمدٍ، ونسبوه كذباً وزوراً إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-، وقد قسّم العلماء الحديث الموضوع إلى قسمين؛ حديثٌ تعمّد الرواة وضعه، وحديث لم يتعمّد الرواة وضعه وإنّما وقع منهم خطأً عن غير قصدٍ، ومن الأمثلة على الأحاديث الموضوعة التي وضعها بعض الناس دون قصدٍ ما رواه ثابت بن موسى الزاهد عن شريك عن الأعمش عن أبي سفيان، عن جابر مرفوعاً قال: "مَنْ كَثُرَتْ صَلَاتُهُ بِاللَّيْلِ حَسُنَ وَجْهُهُ
مفهوم الهداية هناك العديدُ من التعريفات التي وردت في تفسير لفظ الهداية، وفيما يأتي بيان تعريف الهداية لغةً واصطلاحاً: تعريف الهداية لغةً: مصدرٌ من الفعل الثلاثيّ هَدَى، ومعناه الوصول أو الإرشاد إلى المطلوب، وقد يأتي بمعنى طريق الصواب. تعريف الهداية اصطلاحاً: الهداية والرشاد، والتعريف بالطريق الصحيح. أنواع الهداية تتفرع الهداية إلى أقسام ومراتب، وقد فصّل الله -تعالى- أنواعها في القرآن الكريم، فمنها الهداية الخاصّة والهداية العامّة، ومنها الهداية التي شملت الحيوانات، أو الهداية التي اقتصرت على