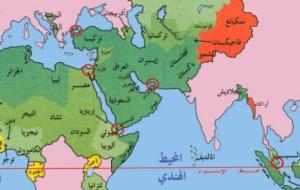أحكام الصيام للمتزوجين

علاقة الزوج بزوجته أثناء الصيام
شرع الله -تعالى- الزواج ، وجعل فيه المودّة والرحمة بين الرجل وزوجته، وجعله أساساً لتكوين الأُسرة المُسلمة التي تُعدّ عماد المجتمع، ومن جانب آخر تجدر الإشارة إلى أنّ التّوجيهات الشرعية المتعلّقة بالعلاقة الزوجية في شهر رمضان توصي الزوجين بالحذر من تبعاتِ الأفعال المقترنة بالشهوة، ولا بأس بالجلوس، والمزاح، والكلام، والتعليم، وغير ذلك، ويُفضَّل اجتناب كلّ ما يُؤدّي إلى الجِماع، كالتقبيل، أو الضمّ، أو المباشرة؛ لأنّها تُعدّ من الشهوات التي امتدح الله -تعالى- الصائم لتركه إيّاها؛ تقرُّباً إليه -سبحانه-، فقد ورد في الحديث القدسيّ: (يَتْرُكُ طَعَامَهُ وشَرَابَهُ وشَهْوَتَهُ مِن أجْلِي الصِّيَامُ لِي، وأَنَا أجْزِي به والحَسَنَةُ بعَشْرِ أمْثَالِهَا)، وعلى الصائم التنبُّه إلى أنّ تلك المحظورات تتفاوت في الخطورة؛ إذ تعدُّ المباشرة أكثرها خطراً على الصائم؛ فقد تتسبّب بالإنزال، وبالتالي إفساد الصيام، وعلى الرغم من إباحة بعض أهل العلم التقبيل، وما شابه ذلك أثناء الصيام، إلّا أنّهم وضعوا شروطاً له، ومنها: أن يأمن الصائم على نفسه عدم الانتقال إلى ما بعد التقبيل، وبالتالي إفساد صيامه، وفي الحقيقة ينبغي للمُتزوّجين الوقوف على العديد من الأحكام الخاصّة بصيام رمضان ، وفيما يأتي بيان بعضها.
أحكام الصيام للمُتزوّجين
حُكم الجِماع للصائم
يُحرّم على الصائم في نهار رمضان جماع زوجته؛ لأنّ الجماع يُعَدّ كالأكل، والشُّرب في اعتباره من مبطلات الصيام ، قال الله -تعالى-: (أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ)؛ فالآية تدلّ على الإِذن بالمباشرة في ليلة الصيام، ويُستفاد من ذلك أنّ الصيام يكون عن الأكل، والشُّرب، والجماع، وسائر المُفطرات.
ويرجع سبب تحريم الجِماع في نهار رمضان، واعتباره من المُفطرات إلى أنّ المقصود من عبادة الصيام كفّ النفس عمّا اعتادت عليه من الشهوات، كالأكل، والشُّرب، لا سيّما أنّ الراحة والانغماس في الشهوات أمر يزيد من وساس الشيطان، ويُضعف العزيمة على العبادات والعمل، والجماع من نِعَم البَدَن، مثله في ذلك مَثلُ الأكل والشُّرب؛ ولذلك حرّمه الله -تعالى- في نهار رمضان، وجعله من المُفطرات، بل رتّب على من أفسد صومه بالجماع كفّارةً مغلّظة.
وقد بيّن أهل العلم أنّ مَن جامع زوجته في نهار رمضان ترتّب عليه الإثم، وبطل صيامه، ووجب عليه إمساك ما تبقّى من النهار؛ إذ إنّ كلّ مَن أفسد صيامه في نهار رمضان بغير عُذرٍ شرعيٍّ، وجب عليه إمساك بقيّة اليوم، بالإضافة إلى وجوب قضاء ذلك اليوم، والكفّارة، ومن الجدير بالذِّكر أنّ كفّارة الجماع في نهار رمضان من أغلظ الكفّارات؛ وهي تكون بعتق رقبةٍ، فإن لم يجد، فصيام شهرَين مُتتابعَين، فإن لم يستطع، فإطعام ستّين مسكيناً، أمّا إن كان الصيام نافلةً وأفطر المُكلَّف بالجماع، فلا يترتّب عليه شيءٌ، وقد بيّن أهل العلم حُكم مَن جامع زوجته في نهار رمضان ناسياً؛ فقالوا بعدم بطلان صيامه؛ قياساً على حكم مَن أَكل أو شَرِب ناسياً، ورفع المؤاخذة عنه، وإنْ كان هذا مستبعدَ الوقوع في صيام الفريضة، خصوصاً أنّه فعل مشترك بين الزوجين.
حُكم التقبيل للصائم
التّقبيل الذي يُفطر الصائم بسببه هو ما نتج عنه إنزال، وهذا بإجماع أهل العلم، أمّا إن لم ينتج عن التقبيل إنزالٌ؛ فيعتمد الحُكم على طبيعة الصائم نفسه؛ فإن كانت القُبلة تُؤثّر فيه، وتُحرّك شهوته، فحُكمها الكراهة، إلّا أنّها لا تُعَدّ مُبطلةٌ للصيام، وقد صحّ عن أمّ المؤمنين عائشة -رضي الله عنها-، أنّها قالت: (كانَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ وَهو صَائِمٌ، وَيُبَاشِرُ وَهو صَائِمٌ، وَلَكِنَّهُ أَمْلَكُكُمْ لإِرْبِهِ)، أمّا إذا كانت القُبلة لا تُؤثّر في الصائم، ولا تُحرّك شهوته، فحُكمها الإباحة، إلّا أنّ الأَولى تركها؛ استدلالاً بما رُوي عن عمر بن الخطّاب -رضي الله عنه-، أنّه قال: (هشَشتُ فقبَّلتُ وأَنا صائمٌ، فقُلتُ: يا رسولَ اللَّهِ صنَعتُ اليومَ أمرًا عَظيمًا قبَّلتُ، وأَنا صائمٌ قالَ: أَرأَيتَ لو مَضمَضتَ منَ الماءِ، وأنتَ صائمٌ قُلتُ: لا بأسَ بِهِ، قالَ: فمَهْ)، وذهب جمهور أهل العلم إلى أنّ علّة الحكم مرجعها إلى تحريك الشهوة أو الإنزال، وتنتقل بين الكراهة والجواز تبعاً لذلك، ولا فرق في الحكم بين الشّاب وكبير السّن، بينما ذهب المالكية إلى كراهة التقبيل للصائم مُطلَقاً، وتجدر الإشارة إلى أنّ أهل العلم اختلفوا في حُكم نزول المذي المُصاحب للتقبيل في نهار رمضان؛ فقال كلٌّ من الإمام أحمد، والإمام مالك -رحمهما الله-؛ بأنّه مُبطِلٌ للصيام، وقال الإمام الشافعيّ، وأبو حنيفة بأنّه غير مُبطِلٍ للصيام.
وتأكيداً على ما سبق؛ فقد استدلّ أهل العلم بما رواه أبو هريرة -رضي الله عنه- أنّه قال: (أنَّ رجلًا سأل النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن المباشَرةِ للصائمِ فرخَّص له وأتاه آخرٌ فسألَهُ فنهاه فإذا الَّذي رخَّص له شيخٌ والَّذي نَهاه شابٌّ)، ولا يخفى أنّ المقصود بالمباشرة الواردة في الحديث لا يتضمّن الجماع، وإنما يقصد بها الملامسة، وما في حكمها كالتّقبيل، وبيّن أهل العلم أنّ النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- لم يُرخّص للشاب؛ لأنّه رأى أنّ شهوته أشدّ من الشيخ الكبير، ممّا يجعله أكثر عُرضةً لِما قد يُفسِد صيامه.
الأحكام المُتعلِّقة بنزول المني للصائم
يُعرَّف المني بأنّه: سائلٌ ثخينٌ لونه أبيض مائلٌ للصُّفرة، رائحته كرائحة طلع النخيل، أو العجين، يخرج دفقاً عند اشتداد الشهوة، ويعقب نزوله فتورٌ في الجسم، والمني طاهرٌ، إلّا أنّه يُوجِب الغُسل ، أمّا المذي فهو: سائلٌ لزجٌ شفّاف اللون، يخرج عند الشهوة من غير تدفُّقٍ، والمذي نَجِسٌ، إلّا أنّه لا يُوجِب الغُسل، بل الوضوء، ومن الجدير بالذكر أنّ حُكم نزول المني يختلف بحسب الوسيلة التي نزل بها؛ فنزوله بسبب التقبيل، أو الملامسة بين الرجل وزوجته، أو الاستمناء يُفسِد الصيام، ويُوجِب القضاء باتّفاق المذاهب الأربعة، إلّا أنّه لا تترتّب على ذلك كفّارةٌ؛ لأنّ حُكم الكفّارة ورد في الجماع دون غيره، أمّا في حال نزول المني بمجرّد التفكير من غير لمسٍ، أو نظرٍ، أو استمناءٍ، أو في حال نام الصائم فاستحلم، وأنزل المني، فلا يُفسِد صيامه، وذلك بإجماع أهل العلم؛ لأنّ الأمر خارجٌ عن إرادته.
وبعد بيان حُكم نزول المني للصائم، يجدر بيان معنى الاستمناء، وحُكمه؛ إذ يُعرّف الاستمناء لغةً بأنّه: طلب خروج المني، واصطلاحاً بأنّه: إنزال المني دون الجماع، كاستعمال اليد، وغير ذلك من الوسائل، والاستمناء مُحرَّمٌ؛ لقول الله -تعالى-: (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ*إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ*فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَـئِكَ هُمُ الْعَادُونَ)، وفي الآية دليلٌ على تحريم الاستمتاع بغير الزوجة، وقد ذهب كلٌّ من المالكيّة، والشافعيّة، والحنابلة، وعامّة الحنفيّة إلى أنّ الاستمناء باليد يُبطل الصيام، وخالفهم أبو القاسم من الحنفيّة؛ إذ قال بأنّ الاستمناء لا يُبطل الصيام؛ لأنّه مختلفٌ كُلّياً عن الجماع، أمّا الاستمناء بالنظر؛ سواءً بالتكرار، أم لا، فقد ذهب كلٌّ من المالكيّة، والحنابلة إلى أنّه مُبطلٌ للصيام، وخالفهم الحنفيّة، والشافعيّة في المعتمد لديهم؛ فقالوا إنّه لا يُبطل الصيام مُطلَقاً، ولا تجب الكفّارة في الحالة السابقة إلّا عند المالكيّة الذين قالوا بوجوبها قطعاً إن تكرّر النظر، وكان الإنزال عادةً.
حُكم صيام الجُنب
ذهب أهل العلم إلى جواز تأخير الغُسل لِمَن جامع زوجته في الليل أو لحقته جنابة إلى أن يُصبح من غير أن يؤثّر ذلك في صحة صيامه، وذهب الإمام النووي إلى أنّ إجماع جمهور العلماء قد استقرّ على ذلك، ومن جملة ما استدلوا به ما أخرجه الإمام مسلم عن أمّ المؤمنين عائشة -رضي الله عنها-، أنّها قالت: (أنَّ رَجُلًا جَاءَ إلى النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ يَسْتَفْتِيهِ، وَهي تَسْمَعُ مِن وَرَاءِ البَابِ، فَقالَ: يا رَسولَ اللهِ، تُدْرِكُنِي الصَّلَاةُ وَأَنَا جُنُبٌ، أَفَأَصُومُ؟ فَقالَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ: وَأَنَا تُدْرِكُنِي الصَّلَاةُ وَأَنَا جُنُبٌ فأصُومُ فَقالَ: لَسْتَ مِثْلَنَا، يا رَسولَ اللهِ، قدْ غَفَرَ اللَّهُ لكَ ما تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَما تَأَخَّرَ، فَقالَ: وَاللَّهِ، إنِّي لأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَخْشَاكُمْ لِلَّهِ، وَأَعْلَمَكُمْ بما أَتَّقِي).
حُكم المُداعبة بين الزوجين أثناء الصيام
حُكم المُداعبة بين الزوجين أثناء الصيام من أحكام الصيام المُتعلِّقة بالمتزوّجين، وقد ذهب أهل العلم إلى جواز المُداعبة بين الرجل وزوجته أثناء الصيام، بشرط التأكُّد من عدم اشتداد الشهوة إلى الحدّ الذي يتمّ فيه إنزال المذي أو المني، وفي حال خشية أحدهما، أو كليهما من إنزال المني أو المذي، فلا تجوز المداعبة؛ لأنّ ذلك ممّا يُعرّض الصيام للفساد، أخرج البخاريّ عن أمّ المؤمنين عائشة -رضي الله عنها-، أنّها قالت: (كانَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُقَبِّلُ ويُبَاشِرُ وهو صَائِمٌ، وكانَ أمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ)، بالإضافة إلى ما رُوِي عن عمر بن أبي سلمة -رضي الله عنه- أنّه سأل رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-: (أَيُقَبِّلُ الصَّائِمُ؟ فَقالَ له رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ: سَلْ هذِه لِأُمِّ سَلَمَةَ فأخْبَرَتْهُ، أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ يَصْنَعُ ذلكَ، فَقالَ: يا رَسولَ اللهِ، قدْ غَفَرَ اللَّهُ لكَ ما تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَما تَأَخَّرَ، فَقالَ له رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ: أَما وَاللَّهِ، إنِّي لأَتْقَاكُمْ لِلَّهِ، وَأَخْشَاكُمْ له)، وفي الحديث دليلٌ على جواز التقبيل للصائم، ويُقاس عليه حُكم المُداعبة، والضمّ، وغير ذلك من مُقدّمات الجماع.